يُعد نهر الكوثر عطاءً خاصًا من الله تعالى لرسوله العظيم صلى الله عليه وسلم، فما هو نهر الكوثر كما وصفه رسول الله؟ وما علاقته بحوض النبي؟
الرسول
صلى الله عليه وسلم
في
مكة أطهر بقاع الأرض أضاء الكون لـميلاد
النبي خاتم النبيين، حيث
وُلد يتيمًا في عام الفيل، وماتت أمه في سنٍّ مبكرة؛ فربَّاه جدُّه عبد المطلب ثم
عمُّه أبو طالب، وكان يرعى الغنم ويعمل في التجارة خلال سنوات شبابه، حتى تزوج من
خديجة بنت خويلد
في سن الخامس والعشرين، وأنجب منها كلَّ أولاده باستثناء إبراهيم.
وفي سنِّ الأربعين نزل عليه الوحي بالرسالة، فدعا إلى عبادة الله وحده ونبذ الشرك،
وكانت دعوته سرِّيَّة لثلاث سنوات، تبعهنَّ عشرٌ أُخَر يُجاهر بها في كل مكان، ثم
كانت الهجرة إلى
المدينة المنوَّرة بعد شدة
بأسٍ من رجال قريش وتعذيبٍ للمسلمين، فأسَّس بها دولة الإسلام، وعاش بها عشر سنوات،
تخلَّلها كثيرٌ من مواجهات الكفار والمسلمين التي عُرِفَت بـالغزوات،
وكانت حياته نواة الحضارة
الإسلامية، التي توسعت في بقعةٍ جغرافيَّةٍ كبيرة على يد
الخلفاء الراشدين من بعده.
ملخص المقال
اتخذ الرسول الكريم طريقة جديدة للحوار مع القبائل الزائرة لمكة، فأصبح يدعوهم إلى نصرته واستضافته في قبائلهم، فماذا فعل رسول الله؟ وماذا عن رد القبائل
دعوة القبائل.. الإجراءات والمنهج
بدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم -بناءً على ما سبق- في تغيير طريقته في الدعوة تغييرًا خطيرًا؛ فهو لن يكتفي الآن بدعوة الناس إلى الإسلام فقط كما كان يفعل من قبل؛ بل سيدعوهم كذلك إلى النصرة ضدَّ قريش، وبشكل صريح!
ولنراجع الروايتين اللتين تتعلَّقان بهذه المرحلة، وقد جاءت الروايتان عن طريق جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، وهو -كما هو معروف- من أهل يثرب الذين لم يظهروا في الصورة إلا مؤخرًا؛ وذلك عندما أسلم سويد بن الصامت وإياس بن معاذ رضي الله عنهما؛ ولعلَّ جابرًا رضي الله عنه قد شاهد هذين الموقفين بنفسه، أو أن أحد أهل يثرب قد حكاهما له، وقد حدَّدنا موعدهما في العام الحادي عشر من البعثة لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن يطلب من أحدٍ النصرة قبل هذا العام لوجود أبي طالب معه؛ ثم إنه لن يطلبها في الفترة المتبقية في العهد المكي لأنه سيجد نصرةً من أهل يثرب -أو المدينة- في هذا العام، كما سنتبيَّن في هذا الفصل بإذن الله؛ ومن ثَمَّ لن يكون هناك حاجة لطلبها من غيرهم، ثم إن الرواية الثانية فيها تحديد صريح حيث ذكر جابر رضي الله عنه ما يدلُّ على حدوث الموقف الأخير في العام الحادي عشر كما سيأتي.
يقول جابر بن عبد الله رضي الله عنهما: كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَعْرِضُ نَفْسَهُ عَلَى النَّاسِ فِي الْمَوْقِفِ[1] فَقَالَ: «أَلَا رَجُلٌ يَحْمِلُنِي إِلَى قَوْمِهِ فَإِنَّ قريشًا قَدْ مَنَعُونِي أَنْ أُبَلِّغَ كَلَامَ رَبِّي»[2].
ويقول كذلك: كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يَعْرِضُ نَفْسَهُ عَلَى النَّاسِ بِالْمَوْقِفِ فَيَقُولُ: «هَلْ مِنْ رَجُلٍ يَحْمِلُنِي إِلَى قَوْمِهِ فَإِنَّ قريشًا قَدْ مَنَعُونِي أَنْ أُبَلِّغَ كَلَامَ رَبِّي عز وجل؟» فَأَتَاهُ رَجُلٌ مِنْ هَمْدَانَ فَقَالَ: «مِمَّنْ أَنْتَ؟» فَقَالَ الرَّجُلُ: مِنْ هَمْدَانَ. قَالَ: «فَهَلْ عِنْدَ قَوْمِكَ مِنْ مَنَعَةٍ؟» قَالَ: نَعَمْ. ثمَّ إِنَّ الرَّجُلَ خَشِيَ أَنْ يَحْقِرَهُ قَوْمُهُ فَأَتَى رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: آتِيهِمْ فَأُخْبِرُهُمْ ثمَّ آتِيكَ مِنْ عَامٍ قَابِلٍ. قَالَ: «نَعَمْ». فَانْطَلَقَ وَجَاءَ وَفْدُ الأَنْصَارِ فِي رَجَبٍ[3].
لقد أتى وفد الأنصار -كما تقول الرواية- بعد انطلاق الرجل الهمداني، وكان هذا في شهر رجب، ومن المعروف أن أول قدومٍ لوفد الأنصار كان في العام الحادي عشر من البعثة؛ ولذلك تمَّ تحديد توقيت بداية هذه السياسة النبوية الجديدة في دعوة الناس.
إن هذا الذي يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم يُعدُّ في الواقع بمنزلة إعلان الحرب على مكة، فقد تقبل قبيلة قوية بالإسلام، وبالنصرة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم تصطدم هذه القبيلة بعد ذلك مع أهل مكة المكذبين له، فتكون حربًا خطيرة، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلم خطورة هذا الأمر؛ ومن ثَمَّ فإنه أراد أن يتكلم مع القبائل والأفراد دون أن تعلم قريش بهذا الحديث، وهذا أمر صعب؛ لأن قريشًا كانت تَتَتَبَّع رسول الله صلى الله عليه وسلم في أثناء قدوم الحجيج والمعتمرين، وتُكَذِّبه في كل موطن، وكان الذي يقوم بهذا الأمر في معظم الأحيان عمُّه أبو لهب، ومن هنا فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرَّر أن يُغَيِّر نسبيًّا من طريقته في الدعوة مع القبائل الغريبة عن مكة.
لقد كان من عادته صلى الله عليه وسلم قبل ذلك أن يتحدَّث حديثًا عامًّا مع الناس جميعًا، فيتحدَّث في أمر الإسلام وسط الأسواق أو نحوها، ويسمعه الناس من كل القبائل؛ أما الآن فهو يُريد أن يتحدَّث بشكل خاصٍّ مع كل فرد أو قبيلة، ولا يتوجَّه بحديثه إلى قبائل متعدِّدة في آنٍ واحد؛ حتى لا يخرج أمره إلى أهل مكة قدر المستطاع؛ خاصة أنه سيطلب النصرة، وقد تكون هناك مفاوضات سياسية أو عسكرية لا يستطيع البوح ببنودها أمام الناس جميعًا، وهذا دفع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى سرية الحديث مع الناس في هذه المرحلة.
وقد تطلَّب هذا الأمر أن يقوم رسول الله صلى الله عليه وسلم ببعض الإجراءات التي تضمن تأمين مثل هذه اللقاءات، وتوفير أفضل فرص النجاح لها؛ وكان من هذه الأمور ما يلي:
أولًا: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذهب إلى هذه القبائل ليلًا[4] حتى لا يلفت أنظار القرشيين، أو أحيانًا يأتيهم في وقت الظهيرة، وهو وقت شديد الحرارة، وتقلُّ فيه حركة الأقدام في مكة.
ثانيًا: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتي القبائل في منازلهم[5] بعيدًا عن الكعبة، فإنه لكثرة القبائل كانت كل قبيلة تقيم مخيَّمًا خارج مكة ليتسع البلد الحرام لكل الزائرين، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينتظر أن يدخلوا إلى البيت الحرام ثمَّ يدعوهم؛ بل كان يذهب إليهم خارج مكة بعيدًا عن أعين المراقبين.
ثالثًا: وهذه نقطة مهمَّة للغاية، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصطحب معه أبا بكر الصديق رضي الله عنه، وأحيانًا علي بن أبي طالب رضي الله عنه؛ وذلك لإشعار القوم أنه ليس وحيدًا في مكة من ناحية، ومن ناحية أخرى أهمَّ وهي أن أبا بكر الصديق كان يعرف أنساب القبائل، فكان يستطيع أن يُمَيِّز بين القبيلة القوية الشريفة والقبيلة الضعيفة القليلة، وهذا أمر في غاية الأهمية، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم سوف يطلب منهم النصرة، فإن ادَّعَوا القوة وهم ليسوا بأقوياء بَنَى رسول الله صلى الله عليه وسلم حساباته على معلومات غير موثَّقة، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسألهم سؤالًا مباشرًا عن عددهم وقوَّتهم، وأبو بكر يُؤَكِّد إجابتهم أو ينفيها، فإن وَجَد منهم رسول الله صلى الله عليه وسلم قوةً عَرَضَ عليهم الإسلام وطلب منهم النصرة، وإن وجد فيهم ضعفًا، عرض عليهم الإسلام ولم يطلب منهم النصرة، فهو يُريد أن يصل بدعوته إلى كل إنسان؛ لكنه في الوقت نفسه يُقَدِّر الموقف السياسي العصيب الذي يمرُّ به، ويحسب لكل موقف حسابه المناسب.
وهكذا بدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم جولاته من جديد، في نشاط وخِفَّة وحميَّة، وكأنَّ الأمور على خير ما يرام، وكأنه لم تكن هناك أحزان تلو أحزان، وكم نرى من المسلمين مَنْ يعتذر عن العمل لله لأن «ظروفه» صعبة، وأحواله متعسرة! لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن يعرف شيئًا عن هذا الاعتذار؛ بل يعمل بكل نشاط مهما كانت الظروف.
بدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم نشاطه تقريبًا في شهر رجب من العام الحادي عشر من البعثة أو قبل ذلك بقليل، وقد أخذنا ذلك التوقيت من إحدى روايتي جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، وقد ذكر فيها أن وفد الأنصار -أي الخزرج- جاء في رجب، وكان هذا بعد أن تواصل رسول الله صلى الله عليه وسلم مع بعض القبائل، ثم كانت خاتمة اللقاءات مع قبيلة الخزرج كما سنشرح بعد قليل، وكانت القبائل العربية تتوافد على زيارة البيت الحرام طوال العام؛ ولكن يكثر قدومهم للعمرة في شهر رجب؛ لكونه من الأشهر الحرم، وهذا يُوَفِّر لهم أمانًا في السفر حيث تُعَظِّمه معظم القبائل، وتُحَرِّم فيه القتال، كما كانوا يتوافدون بكثافة كذلك في موسم الحج في ذي القعدة وذي الحجة.
لقد تكلَّم رسول الله صلى الله عليه وسلم في أمر الإسلام والنصرة في هذا الموسم مع عدد كبير من القبائل، فلم يكل ولم يمل صلى الله عليه وسلم، ولقد رفضوه جميعًا إلا أفرادًا قلائل من قبيلة واحدة! ومع ذلك فقد غيَّر هؤلاء الأفراد من مسار الأحداث، لا أقول في الجزيرة العربية وحدها؛ بل أقول في العالم أجمع! وكان هؤلاء الأفراد من قبيلة الخزرج اليثربية! فكان الإيمان الذي مهَّد لقيام الدولة الإسلامية.
والواقع أنه ليست بين أيدينا تفصيلات كثيرة عن معظم هذه اللقاءات المهمَّة، ومع ذلك فما توافر لدينا من روايات يعطينا فوائد لا حصر لها، وسنقف وقفة مع كل قبيلة دعاها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم نختم الحديث بشرح موقفه صلى الله عليه وسلم مع الخزرج في المقالات التالية بإذن الله.
[1] الموقف؛ أي الموسم. انظر: المباركفوري: تحفة الأحوذي 8/195، وفي رواية النسائي وابن ماجه: «يَعْرِضُ نَفْسَهُ عَلَى النَّاسِ فِي الْمَوْسِمِ». والمقصود موسم الحج، فقد كانوا يحجون في الجاهلية كما ذكرنا ص40.
[2] أبو داود: كتاب السنة، باب في القرآن (4734)، والترمذي (2925)، وقال: حديث غريب صحيح. والنسائي (7727)، وابن ماجه (201)، والدارمي (3354)، وقال حسين سليم أسد: إسناده صحيح. وصححه الألباني، انظر: السلسلة الصحيحة (1947).
[3] أحمد (15229)، وقال شعيب الأرناءوط: إسناده صحيح على شرط البخاري رجاله ثقات. والحاكم (4220)، وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي، وقال الهيثمي: رواه أحمد، ورجاله ثقات. انظر: مجمع الزوائد 6/35.
[4] عن عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ رضي الله عنه أَنَّهُ قَالَ: بَايَعْنَا رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لَيْلَةَ الْعَقَبَةِ الْأُولَى. انظر: ابن هشام: السيرة النبوية 1/434، وقَالَ كَعْبٌ: فَلَمَّا فَرَغْنَا مِنَ الْحَجِّ، وَكَانَتِ اللَّيْلَةُ الَّتِي وَاعَدْنَا رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لَهَا... قَالَ: فَنِمْنَا تَلِكَ اللَّيْلَةَ مَعَ قَوْمِنَا فِي رِحَالِنَا، حَتَّى إذَا مَضَى ثُلُثُ اللَّيْلِ خَرَجْنَا مِنْ رِحَالِنَا لِمَعَادِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، نَتَسَلَّلُ تَسَلُّلَ الْقَطَا مُسْتَخْفِينَ، حَتَّى اجْتَمَعْنَا فِي الشِّعْبِ عِنْدَ الْعَقَبَةِ. انظر: ابن هشام: السيرة النبوية 1/441، والطبري: تاريخ الرسل والملوك، 2/361، وقال أبو حاتم: فلما كان الموسم جعل النبي صلى الله عليه وسلم يتبع القبائل يدعوهم إلى الله، فاجتمع عنده بالليل اثنا عشر نقيبًا من الأنصار. انظر: ابن حبان: السيرة النبوية وأخبار الخلفاء 1/106، وراجع مرور رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر الصديق رضي الله عنه في طرق مكة بعد أن نامت قريش في قصة إسلام أبي ذر رضي الله عنه ص617.
[5] عَنْ جَابِرٍ رضي الله عنه، قَالَ: مَكَثَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِمَكَّةَ عَشْرَ سِنِينَ، يَتْبَعُ النَّاسَ فِي مَنَازِلِهِمْ بعُكَاظٍ وَمَجَنَّةَ، وَفِي الْمَوَاسِمِ بِمِنًى، يَقُولُ: «مَنْ يُؤْوِينِي؟ مَنْ يَنْصُرُنِي حَتَّى أُبَلِّغَ رِسَالَةَ رَبِّي، وَلَهُ الْجَنَّةُ؟». أحمد (14496)، وقال: شعيب الأرناءوط: إسناده صحيح على شرط مسلم. وابن حبان (6274)، والحاكم (4251)، وقال: هذا حديث صحيح الإسناد جامع لبيعة العقبة ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي، وصححه الألباني، انظر: السلسلة الصحيحة (63). وذكر ابن إسحاق عرض النبي صلى الله عليه وسلم نفسه على بني كلب وبني عامر وكندة وبني حنيفة في منازلهم. انظر: ابن هشام: السيرة النبوية 1/422-425، والطبري: تاريخ الرسل والملوك 2/349-351، وابن كثير: البداية والنهاية 3/170، والسيرة النبوية 2/157.








![نصيحتي لك: اذكر الله [1 / 12] نصيحتي لك: اذكر الله [1 / 12]](https://en.islamstory.com/images/upload/content_thumbs/1913613138ragheb-al-serjany-videos.jpg)
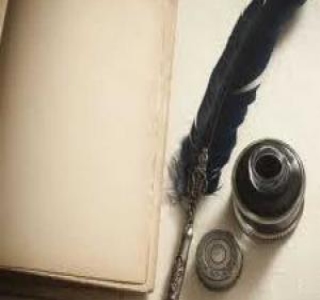

التعليقات
إرسال تعليقك